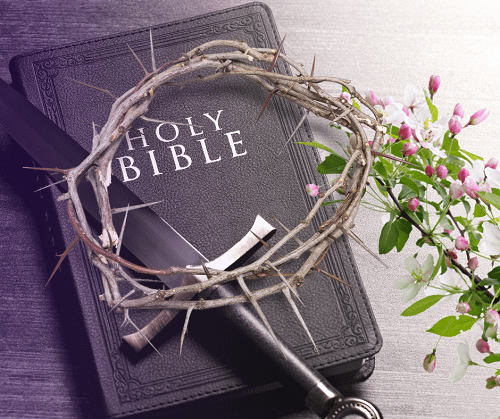«لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لأُلْقِيَ سَلاَمًا بَلْ سَيْفًا» (مت ١٠: ٣٤)
الأعداد متى ١٠: ٣٤ – ٤٢ تُمثل فصلاً مأساويًا وصارخًا من قصة العداوة بين الشر والخير، وهي قصة قديمة، تعود إلى بداية السقوط في الجنة (تك ٣). هناك وُضعت العداوة في قلب الحية وقلب نسلها تجاه كل مَن يحمل اسم الله، ويريد إكرامه (تك ٣: ١٥). وهنا نجد إعلانًا آخر عن رفض الملك ورسالته، فلو قُبِل المسيح من أمته لحل السلام ربوع الأرض، أما وقد رفضه الأكثرون، فعلى الأقلية التي قبلته ألا تتوقع سلامًا على الأرض.
ولا حاجة لنا أن نقول إن فريق المؤمنين بالمسيح لن يستخدموا السيف لقتال الذين رفضوا الإيمان، فالمسيح علَّمنا أن نُحب الأعداء، ونُصلي للمُسيئين إلينا. وأسلوب القتل ليس هو الأسلوب المسيحي (رؤ ١٣: ١٠). وفي هذا قال المُرنم: «طَالَ عَلَى نَفْسِي سَكَنُهَا مَعَ مُبْغِضِ السَّلاَمِ. أَنَا سَلاَمٌ، وَحِينَمَا أَتَكَلَّمُ فَهُمْ لِلْحَرْبِ» (مز ١٢٠: ٦، ٧). على العكس من ذلك فإن المسيحي يعرف سلاحًا آخر هو سلاح الصلاة. وصلاة استفانوس لأجل قاتليه نتج عنها تغيير شاول الطرسوسي إلى بولس الرسول.
أما هذا العالم البائس، فنحن لا ننسى أن أول صفحة في تاريخه بعد سقوط الإنسان في الخطية والطرد من الجنة كانت قتلاً بدوافع دينية، من أخ شقيق يقتل شقيقه (تك ٤: ١ – ١٦). وفي ملء الزمان أتى رئيس السلام ورُفِض، ونتيجته مجيئه ورفضه حدث انقسام خطير في العالم، بل وأحيانًا في العائلة الواحدة.
«لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لأُلْقِيَ سَلاَمًا بَلْ سَيْفًا» (ع ٣٤)
هذه الآية حيَّرت بعضهم؛ فكيف يقول المسيح إنه أتى ليلقي سيفًا لا سلامًا؟ وكيف أتى ليُفرق العائلة الواحدة. لكن هذا ليس عيب المسيح أو الإنجيل أو الأتقياء، بل عيب البشر الأشرار، كقول المرنم الذي أشرنا إليه في مزمور ١٢٠: ٦، ٧.
من جهة المسيح نحن نعلم أن المسيح هو ”رئيس السلام“ (إش ٩: ٦)، وبولادته هدى أقدامنا إلى طريق السلام (لو ١: ٧٩)، وبصليبه أرسى قواعد السلام (أف ٢: ١٤)؛ وبإنجيله عرَّفنا طريق السلام (أف ٦: ١٥؛ رو ٣: ١٧)، وعمل من المؤمنين ”صانعي سلام“ (مت ٥: ٩؛ ١بط ٣: ١١)، لكن مع كل هذا على تلاميذ المسيح ألا يتوقعوا في هذا العالم سلامًا بل سيفًا، وعليهم أن يستعدوا للتضحية بأقرب العلاقات الطبيعية الأرضية وأوثقها، إذا ما اصطدمت بالولاء والأمانة للمسيح (ع ٢٤ – ٢٨). ولكي يُمكننا فهم هذه الآية بصورة أفضل علينا ملاحظة الآتي:
أولاً: علينا أن نُميِّز بين غرض إرسالية المسيح من جانب، ونتيجة هذه الإرسالية من الجانب الآخر. فالمسيح لما وُلد سبَّحت الملائكة قائلة: «الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ» (لو٢: ١٤). هذا هو غرض مجيء المسيح للعالم، وهو حتمًا سيتحقق في وقته، يوم يملك المسيح على الأرض «فَيَطْبَعُونَ سُيُوفَهُمْ سِكَكًا، وَرِمَاحَهُمْ مَنَاجِلَ. لاَ تَرْفَعُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ سَيْفًا، وَلاَ يَتَعَلَّمُونَ الْحَرْبَ فِي مَا بَعْدُ» (إش ٢: ٤). وتأخُّر مُلك المسيح يرجع إلى أنه يوم يملك، سيملك بالبر والعدل، بمعنى أنه سيقضي على الأشرار والرافضين، وسيُنقي ملكوته من المعاثر وفاعلي الإثم. لكن المسيح في مجيئه الأول، ولغاية اليوم، يُمارس النعمة في تعامله مع البشر.
طبعًا كان من الممكن أن تنعم الأرض بالسلام لو أنها قبلت المسيح. لكن حيث إنها رفضت إرساليته، كما أوضح المسيح في هذه العظة، فإن النتيجة الحتمية لذلك أن انسحب السلام من العالم. وهناك اختلاف له مدلوله الجميل في هذا الصدد، فبينما يرد في أول إنجيل لوقا قول الملائكة: «الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ»، ففي آخر الإنجيل ترد تسبيحة أخرى: «سَلاَمٌ فِي السَّمَاءِ وَمَجْدٌ فِي الأَعَالِي!» (لو ١٩: ٣٨). في التسبيحتين نقرأ أن المجد في الأعالي، ولكن بينما في بداية الإنجيل نقرأ ”وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ“، ففي آخره ينسحب السلام من الأرض إلى السماء ”سَلاَمٌ فِي السَّمَاءِ“. فبرفض المسيح أصبح السلام في الأفق البعيد، بينما الصليب هو الذي كان قريبًا.
ثانيًا: أن العالم لا يمكن بحالته الراهنة أن ينعم بالسلام. فحيث أن الخطية منتشرة في كل مكان، وحيث إننا في زمان أناة الله ونعمته، وهو لا يقضي فورًا على الأشرار، فلا يمكن أن يكون السلام في الأرض. لكن في مجيء المسيح الثاني، عندما يُرسل ابن الإنسان ملائكته فينقون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ساعتها سيُقيم الله مُلك السلام، وسيعم السلام ربوع الأرض.
إذًا فالعالم في شره وعدائه لله ينطبق عليه قول النبي: «لاَ سَلاَمَ، قَالَ الرَّبُّ لِلأَشْرَارِ» (إش ٤٨: ٢٢؛ ٥٧: ٢١). ومع ذلك فإن أتباع المسيح لهم سلام داخلي، قال عنه المسيح: «سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا» (يو ١٤: ٢٧). وقال أيضًا: «قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلاَمٌ. فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ» (يو ١٦: ٣٣). ونحن يجب علينا، على قدر طاقتنا، أن نُسالم جميع الناس، وأن نطلب السلام، ونجِّد في إثره (١بط ٣: ١١). على أنه سيأتي قريبًا اليوم الذي فيه يعم السلام ربوع العالم، وذلك يوم يملك المسيح (انظر مز ٤٦: ٩؛ إش ٩: ٧؛ حز ٣٤: ٢٥؛ مي ٥: ٥؛ زك ٦: ١٣؛ ٩: ١٠؛ …).
«فَإِنِّي جِئْتُ لأُفَرِّقَ الإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ، وَالاِبْنَةَ ضِدَّ أُمِّهَا، وَالْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا. وَأَعْدَاءُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ» (ع ٣٥، ٣٦).
حرف الفاء في أول هذه الآية يربط الكلام اللاحق بالكلام السابق. وكما فهمنا لم يكن غرض مجيء المسيح أن يُفرِّق بين أفراد الأسرة الواحدة، بل إنها النتيجة الحتمية لدخول الإيمان بالمسيح في عائلة، لم يقبله كل أفرادها. البعض قَبِلَ المسيح باعتباره مُخلِّصه وربه، والبعض الآخر رفض الإيمان بالمسيح. فماذا يحدث والحال هكذا؟ الذين رفضوا الإيمان بالمسيح سيقومون على من قَبِله. وقصة الرجل المولود أعمى الواردة في يوحنا ٩ تُعطينا تصويرًا قويًا لهذه الحقيقة. فنتيجة إيمانه بالمسيح تنكَّر له أبواه، وأما اليهود فقد أخرجوه خارج المجمع، أي جردوه من امتيازاته الدينية (ع ٢١، ٢٢).
والجزء الأخير من هذه الآية مقتبس من نبوة ميخا النبي. وطبعًا ليس المقصود بهذه الآية أن من يؤمن بالمسيح عليه أن يُعادي الطرف الذي لم يؤمن، على العكس إنه سيُظهر له المحبة الإلهية الحقيقية، ولكن الطرف الذي رفض الإيمان هو الذي سيُظهر كل العداء لمن آمن. وهذا يُمَثِّل آلامًا شديدة على المؤمن، ولا توجد طريقة لتجنب مثل هذه المتاعب إلا إنكار المسيح، لكن المسيح كان لتوه قد حذر من ذلك بعبارات قوية، وكررها في الأقوال التالية مرة أخرى.
«مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوِ ابْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي وَمَنْ لاَ يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي. مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا» (ع ٣٧ – ٣٩).
هي علامة أخرى على صحة إيمان الشخص، أنه لا يسمح لشيء أن يسمو على علاقته بالمسيح. فيتحتم أن يكون المسيح متقدمًا في كل شيء (كو ١: ١٨). ولا يصح للمؤمن أن يسمح للروابط العائلية أو الطبيعية أن تجعله يحيد عن طريق الولاء للرب. فإن لم تأتِ دعوة المسيح على قمة كل الأولويات، فهذا دليل على أن الشخص لا يستحق المسيح. لقد أحبنا المسيح ومات لأجلنا، ولا ينبغي لأي أحد أن يأخذ في قلوبنا مكانًا متفوقًا عليه. هل هذا يبدو صعبًا؟ قال مارتن لوثر: ”لو أن الإنجيل الذي نكرز به يُقبَل بسهولة من الإنسان، لا يكون هذا الإنجيل حقيقيًا“.
ونحن في العهد القديم نجد علامة تحذير واضحة في شخصية يوناثان، صديق داود، لقد حلف له داود باسم الرب أنه سيكون ثانيًا في مملكته، عندما يستلم مُلْكَه من الرب، ولكنه بالأسف قُتل فوق جبال جلبوع، لأنه فضَّلَ البقاء مع أبيه عن اتباع مسيح الرب في البراري والمغاير. ومن هذا نتعلَّم أن مَن لا يحمل عار وليد بيت لحم، ونجار الناصرة، وشهيد الجلجثة، لا يكون مؤهلاً للتمتع بثقل أمجاده.
والمسيح لم يكتفِ بأن قال إنه ينبغي أن يكون أغلى من الأب والأم، بل يستطرد قائلاً إنه ينبغي أن يكون أغلى من حياة الإنسان نفسها، فمن يضِّن بحياته من أن تُنفق في الشهادة للمسيح سيخسرها، وأما مَن يفقد حياته من أجل المسيح فسيربحها.
المسيح في محبته لنا وضع نفسه (في٢: ٨)، وبذل نفسه (مر١٠: ٤٥)، وسكب للموت نفسه (إش٥٣: ١٢). فلا غرابة أن يتطلب منا تكريسنا كله، وحب قلبنا له.
وترد في الآية التي ندرسها أول إشارة للصليب في العهد الجديد. والصليب بصفة عامة يُحدِّثنا عن ميتة قاسية بالإضافة إلى كونها ميتة الاحتقار والعار. وقد كانت العادة قديمًا أن المحكوم عليه بالصلب يحمل صليبه إلى مكان تنفيذ الحكم. والمسيح هنا يقول إن على التلميذ أن يكون متسلحًا دائمًا بفكرة رفض العالم له، وأيضًا بنية الألم لأجل شخصه الكريم. ومن الجانب الآخر فإننا هنا نرى موقف العالم المناوئ لله ولمسيحه. ولقد كان هذا الموقف واضحًا تمامًا في الصليب وتمت كلمات المزمور الثاني: «لِمَاذَا ارْتَجَّتِ الأُمَمُ، وَتَفَكَّرَ الشُّعُوبُ فِي الْبَاطِلِ؟ قَامَ مُلُوكُ الأَرْضِ، وَتَآمَرَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الرَّبِّ وَعَلَى مَسِيحِهِ، قَائِلِينَ: لِنَقْطَعْ قُيُودَهُمَا، وَلْنَطْرَحْ عَنَّا رُبُطَهُمَا» (مز ٢: ١ – ٣؛ أع ٤: ٢٥، ٢٦). والعالم إلى الآن لم يتغيَّر، فرئيس هذا العالم ما زال هو الشيطان. والمسيح في حديث العلية أوضح «إِنْ كَانَ الْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ» (يو ١٥: ١٨). وليس بكثير أن نتألم كمؤمنين لأجل خاطر المسيح الذي سبق أن احتمل الصليب من أجلنا. ومع أن الولاء للمسيح في هذا العالم هو أمر مُكلِّف، لكن على المؤمن أن يشكر الله لأنه في هذا الجانب يقف، وليس في الجانب الآخر. نعم عليه أن يشكر الله لأنه في صف المسيح يتألم الآن من الشيطان، وليس في صف الشيطان الآن ليُدان في المستقبل من المسيح.
وغني عن البيان أن المسيح هنا لا يبيع الخلاص بالاستشهاد لأجله، فالخلاص هو عطية الله بالنعمة، وليس من أعمال من أي نوع (أف ٢: ٨، ٩)، لكن الاستعداد للموت والاستشهاد يبرهن على حقيقة الإيمان وأصالته.
وفي الآية ٣٩ ذكر المسيح كل ما في هذا العالم من جاذبيات أرضية ومسرات جسدية ومتع دنيوية تهفو إليها قلوب البشر، وجمعها في كلمة واحدة: ”وَجَدَ حَيَاتَهُ“. وهذا الذي وَجَدَ حَيَاتَهُ يخيل له أنه نال مناه وأصبح لحياته معنى، لكن الرب يقول هنا عن هذا الإنسان إنه ”أَضَاعَ حَيَاتَهُ“. ويا لهول الخسارة! لقد ضاعت حياته سُدى، بينما الذي أضاع حياته من أجل المسيح يجدها. ولأهمية الأقوال الواردة هنا فقد كررها المسيح في البشائر الأربع سبع مرات، هنا المرة الأولى، ثم نجدها بعد ذلك في متى ١٦: ٢٥؛ مرقس ٨: ٣٥؛ لوقا ٩: ٢٤؛ ١٤: ٢٧؛ ١٧: ٣٣؛ يوحنا ١٢: ٢٥. فنحن إذا أحببنا حياتنا على الأرض أكثر من السَيِّد، سنفقدها، أما إذا فقدناه، في محبة لسَيِّدنا، أي لم نبحث عن رضانا الشخصي، سنجدها، وهذا سيكون للأبد.
ومع أن التعب قد يكون نصيبنا هنا، لكن الراحة الباقية وثقل المجد ينتظراننا هناك عن قريب في السماء. فالمسيحية إن كانت تُقدِّم رفضًا وصليبًا في الحياة الحاضرة، لكن الأكاليل ستكون من نصيبنا في النهاية.
وهناك خطآن في فهم ما يقصده المسيح من حَمل الصليب:
فليس المقصود من حَمل الصليب الآلام التي كل البشر مُعرَّضون لها. فأحيانًا تكون لشخص ظروفه الصحية السيئة، أو تكون في حياته مشاكل عائلية، فيقول بعضنا إن هذا الشخص صليبه ثقيل. ليس هذا ما يقصده المسيح هنا.
والخطأ الثاني أنه لا علاقة لحمل الصليب بالآلام الكفارية التي احتملها المسيح نيابة عنا، فهذه الآلام أنهاها المسيح، وليس لنا أن نُشاركه فيها.